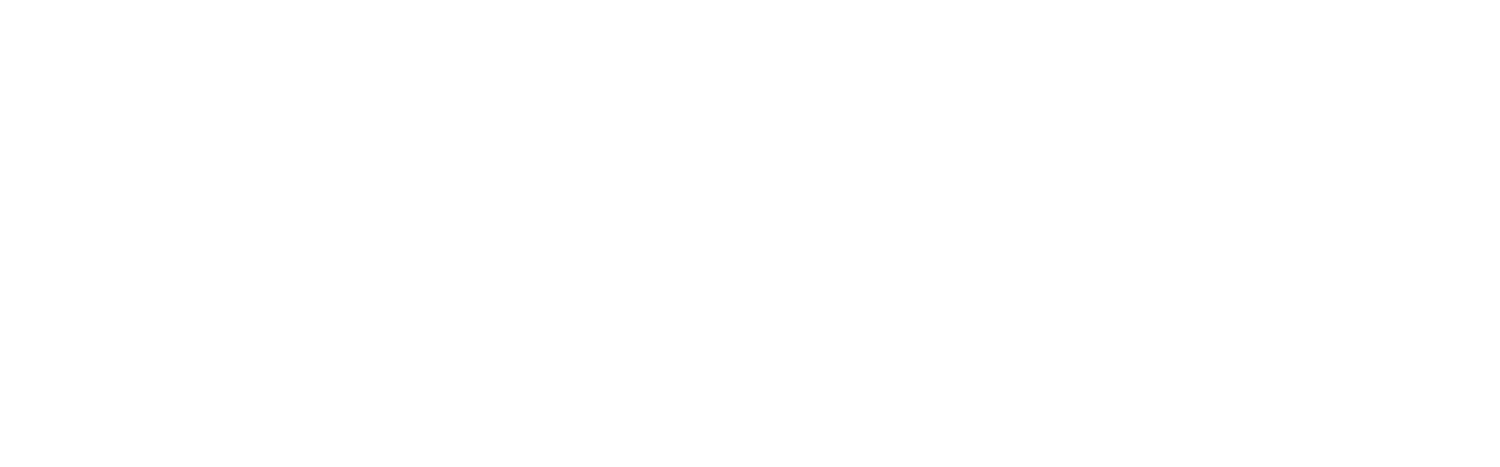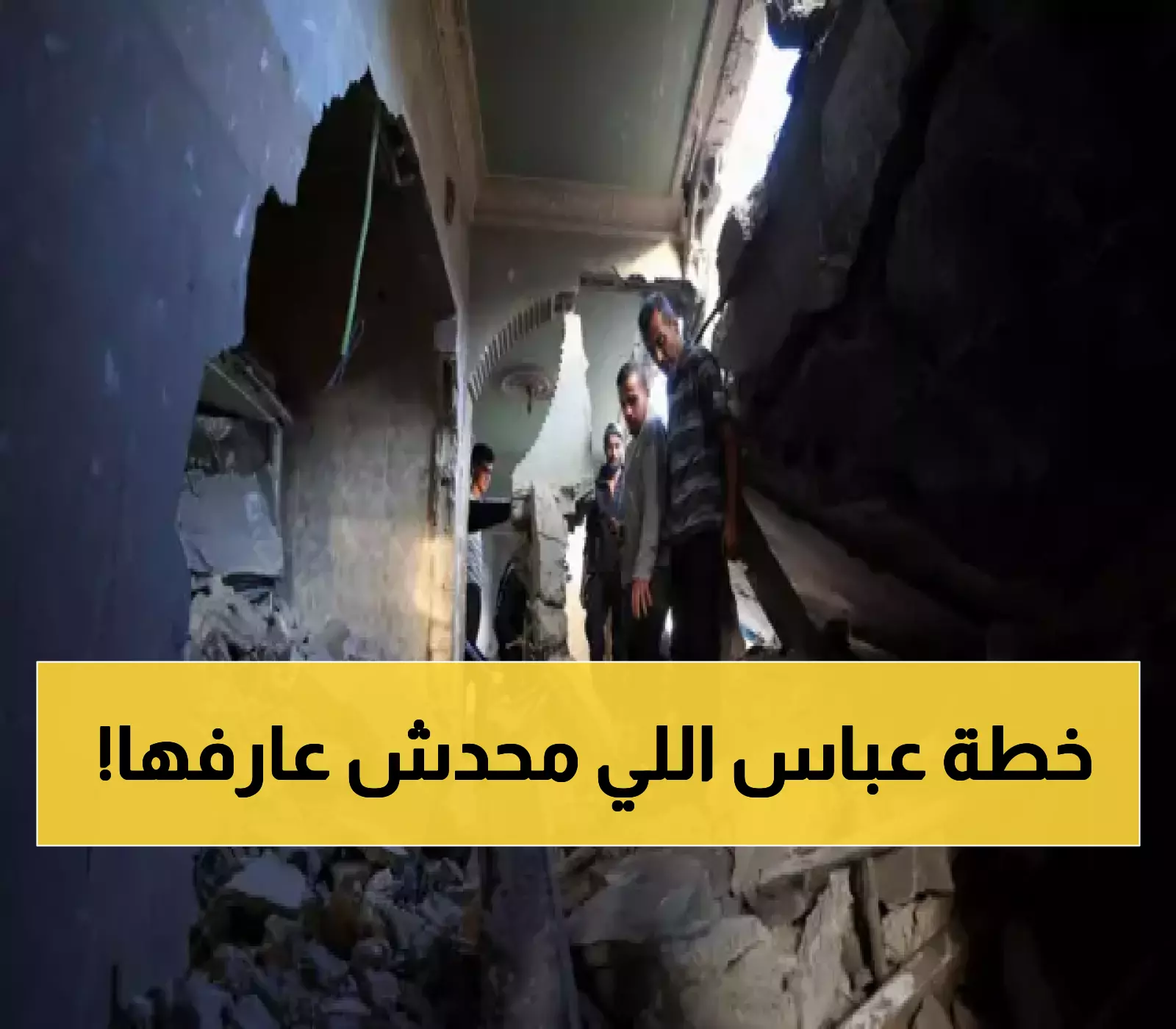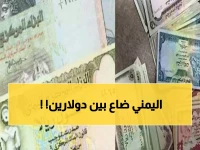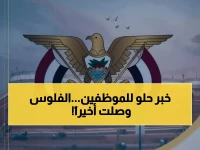أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً يحدد آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئيس، وسط سيطرة إسرائيلية على 53% من قطاع غزة وضغوط دولية متزايدة لترتيب مرحلة ما بعد الحرب. الإعلان الذي جاء بتوقيت حساس قبل تسعين يوماً من الموعد المحدد لإجراء انتخابات فلسطينية، أثار جدلاً واسعاً حول دوافعه الحقيقية ومدى تأثيره على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
ينص الإعلان الدستوري على أنه "في ظل غياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس دولة فلسطين مهام الرئاسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات لاختيار رئيس جديد". هذا التوقيت المحدد يكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة وتعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني.

المدة الزمنية المحددة بتسعين يوماً تطرح تساؤلات جوهرية حول إمكانية إجراء انتخابات حقيقية في ظل الأوضاع الراهنة. فبينما تسيطر إسرائيل على أكثر من نصف قطاع غزة، وتستمر عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، تبدو فرص إجراء انتخابات شاملة وعادلة محدودة للغاية. الإعلان يتضمن بنداً يسمح بتمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي لمرة واحدة في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب "قوة قاهرة".
يرى الباحث الفلسطيني جهاد حرب أن هذا الإعلان "جاء مكملاً للإجراءات التي اتخذها الرئيس عباس في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تعديل مكانة حسين الشيخ داخل النظام السياسي، بهدف تأمين انتقال منظم للسلطة في المستقبل". هذا التحليل يشير إلى أن القرار ليس مجرد إجراء دستوري روتيني، بل جزء من استراتيجية أوسع لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
الضغوط الخارجية تلعب دوراً محورياً في توقيت هذا الإعلان. حرب يوضح أن القرار جاء "في إطار ضغوط عربية تتعلق بضمان انتقال سريع ومنظم للسلطة في حال شغور منصب الرئيس الفلسطيني الذي يبلغ نحو 90 عاماً"، مشيراً إلى أن هذه الضغوط "صدرت من السعودية والإمارات وبعض الدول العربية الأخرى". هذا البعد الإقليمي يعكس اهتماماً عربياً متزايداً بضمان استقرار القيادة الفلسطينية في مرحلة حساسة.
على الصعيد الأمريكي، تشير التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب حول محمود عباس إلى وجود ضغوط دولية مماثلة. ترامب صرح بأنه "يحب محمود عباس لكنه لا مكان له مستقبلاً"، وهو ما يعكس رؤية أمريكية واضحة لضرورة تغيير القيادة الفلسطينية. هذه التصريحات تضع السلطة الفلسطينية أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على الشرعية الداخلية والاستجابة للضغوط الخارجية.
حركة حماس انتقدت القرار بشدة، ووصفت ما جرى بأنه "تعقيد لإمكانية إصلاح النظام السياسي". المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قال إن التغييرات التي تجريها السلطة "تسببت في تشويه عميق للنظام السياسي" لأنها تمت "بشكل منفرد ومخالف للقانون الأساسي وبعيداً عن التوافق الوطني". هذا الموقف يعكس عمق الانقسام الفلسطيني ويطرح تساؤلات حول شرعية أي قرارات تُتخذ دون توافق وطني.
الباحث مأمون أبو عامر يرى أن "جوهر الأزمة يكمن في غياب النظام المؤسسي داخل السلطة الفلسطينية، إذ تم تعطيل المجلس التشريعي بقرار من الرئيس دون وجود بديل قانوني أو تنظيمي". هذا التحليل يضع الإصبع على نقطة محورية: كيف يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي للسلطة في ظل غياب المؤسسات المنتخبة؟

الوضع في غزة يضيف تعقيداً إضافياً للمشهد. مع سيطرة إسرائيل على 53% من القطاع وإصرار السلطة الفلسطينية على تولي إدارته بعد الحرب، يطرح الإعلان الدستوري أسئلة حول قدرة القيادة الجديدة على التعامل مع هذا التحدي. حرب يشير إلى أن الإعلان "قد يتيح للرئيس تفويض نائبه بصلاحيات محددة أو موسعة في قطاع غزة تحديداً، في إطار سعي السلطة لتثبيت حضورها هناك".
مستشار الرئيس محمود الهباش نفى أن يكون القرار جاء نتيجة لضغوط خارجية، مؤكداً أن الإعلان "جاء لتحصين النظام السياسي وتأمين انتقال منظم للسلطة". الهباش أوضح أن عملية إصلاح السلطة "مستمرة وتأخذ أشكالاً مختلفة بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن من الأداء الحكومي وحماية المشروع الوطني". هذا الموقف الرسمي يحاول تقديم القرار كخطوة داخلية طبيعية، لكنه لا يلغي التساؤلات حول التوقيت والدوافع.
التحدي الأكبر الذي يواجه هذا الإعلان يكمن في مسألة الشرعية. أبو عامر يوضح أن "الحالة الفلسطينية مشوشة تماماً من الناحية الدستورية"، مشيراً إلى أن الرئيس "حل المجلس التشريعي رغم أن القانون الأساسي لا يمنحه هذه الصلاحية". مع تعطيل الانتخابات منذ عام 2006، وإلغاء الانتخابات المقررة عام 2022، تبدو الحالة الفلسطينية أمام معضلة دستورية حقيقية.
الإعلان الدستوري يثير أيضاً أسئلة حول مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية. أبو عامر يشير إلى أن المنظمة "تواجه إشكاليات قانونية منذ سنوات، إذ لم يحدث توافق وطني على تشكيل لجنتها التنفيذية منذ فترة طويلة، بينما لا تزال فصائل وازنة مثل حماس والجهاد الإسلامي خارجها". هذا الوضع يضعف شرعية القرارات الصادرة عن المنظمة ويعقد مسألة التمثيل الفلسطيني.
أما بشأن الـ عين أندية أوروبا على أشبال المغرب واجتماعات القاهرة الأخيرة، فإن الهباش يؤكد أن "ما جرى لم يكن اتفاقاً، بل اجتماعاً بين أحزاب غابت عنه حركة فتح، وبالتالي فإن ما يصدر عنه لا يكون ملزماً للآخرين". هذا الموقف يعكس رفضاً فلسطينياً رسمياً لأي ترتيبات تتم دون مشاركة السلطة الفلسطينية، ويؤكد على حصرية القرار في يد منظمة التحرير والسلطة الشرعية.
التساؤل الأهم الذي يطرحه هذا الإعلان يتعلق بقدرة النظام السياسي الفلسطيني على التجديد الحقيقي. حرب يلاحظ أن "الشيخوخة قد تمتد لتصيب مختلف مفاصل النظام"، حيث أن نائب الرئيس في الستينات من عمره، ورئيس المجلس الوطني يبلغ نحو 75 عاماً. هذا الوضع يطرح أسئلة حول مدى جدية الحديث عن تجديد الدماء في النظام السياسي الفلسطيني.
أبو عامر يرى أن "أي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من احتياجات الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها تعزيز الشفافية واستقلال القضاء وضمان وجود مجلس تشريعي منتخب". هذا التأكيد على ضرورة الإصلاح المؤسسي الشامل يضع الإعلان الدستوري في سياق أوسع من التحديات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني.
الإعلان الدستوري يأتي في لحظة تاريخية دقيقة، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية والتطورات الإقليمية. مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من غزة، وتعقيدات المشهد السياسي في الضفة الغربية، يبدو أن المدة الزمنية المحددة بتسعين يوماً للانتخابات قد تكون أكثر رمزية من كونها عملية.
في النهاية، يكشف هذا الإعلان الدستوري عن معضلة أساسية في النظام السياسي الفلسطيني: كيف يمكن تحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة في ظل غياب المؤسسات المنتخبة والضغوط الخارجية المتزايدة؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على مواجهة التحديات الكبرى في المرحلة القادمة.