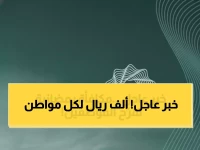يسعى السرد الروائي السينمائي دائماً إلى أسر انتباه المشاهد منذ اللحظات الأولى لعرض الفِلْم، فيبذل المخرجون قصارى جهودهم ليضمنوا ذلك.
وهذا ما سعى إليه المخرج السعودي الشاب عبدالعزيز الشلاحي في تحقيق فلمه الطويل الأول “المسافة صفر"، ونجح بالفعل في جعل فلمه هذا جذَّاباً وشيِّقاً وغامضاً في الوقت نفسه.
عادة، يتوقَّف عنصر الجذب في اللحظات الأولى من أي فِلْم، ومن ثم طوال مدة عرضه، على توفُّر عدد من العناصر الأساسية التي غالباً ما تختلف بين فِلْم وآخر، ولكنها تبلغ أهميتها القصوى في أفلام التشويق والغموض.
ومن أهم هذه العناصر الممكِّنة من الاستحواذ على انتباه المشاهد الإيقاع السردي المتسارع، والحدث المفاجئ، والمونتاج الذي يكفل تداخل اللقطات بمددها الزمنية التي يُستحسن أن تكون قصيرة، فتؤدي بالمشاهد إلى الترقُّب وتشدُّ حواسه وعقله، وغير ذلك.. ولكن الشلاحي لم يتبع كل ذلك في فلمه "المسافة صفر" الذي جاء بهذا العنوان للإشارة إلى أن لا مسافة على الإطلاق بين البطل والفاعل المؤثر في مجرى الأحداث.
تبلغ مدة عرض هذا الفلم 73 دقيقة، كتبه للشاشة مفرج المجفل، وأنتجته جمانة زاهد بدعم من مركز إثراء، وقام ببطولته كلٌ من خالد الصقر، ويعقوب الفرحان، وأسامة صالح، وعبدالله الزيد، وإبراهيم الحساوي، وإلهام علي.
ولو تأملنا التقنية التي اتبعها المخرج عبدالعزيز الشلاحي، سنجد أنه اعتمد على إيقاع بطيء، سواء في حركة الكاميرا أو طول اللقطات، وحتى في حركة الممثلين وحواراتهم، وكذلك في المؤثرات البصرية والصوتية والضوئية. وبالتالي، تخلَّى عن الإيقاع المحموم والحوارات المتوترة والأداء المشحون بالحركة السريعة والانفعالات العاطفية الحادة. فهل هذه ميزة الفلم أم نقيصته؟
وتدور أحداث فِلْم "المسافة صفر" في عام 2004م، حول "ماجد" (خالد الصقر) المصوِّر الفوتوغرافي وصاحب استوديو تصوير في وسط العاصمة الرياض، ورفيقه "لامي" (يعقوب الفرحان) الذي أُودع السجن بتهمة الضلوع في الإرهاب.
وبعد أن هرب ماجد من ماضيه المضطرب، يجد نفسه وسط واقع غريب، عندما يعثر فجأة على علبة دواء لعلاج اضطرابات الذاكرة تحمل اسمه. كما يجد صورة لجثة على أرض شقته، ومسدساً ذا رصاصة ناقصة في سيارته، وغير ذلك من مفارقات وأمور غير متوقعة تؤكِّد إصابته بالألزهايمر والنسيان المتكرر، فيحاول جاهداً بمعاونة خطيبته "أبرار" (إلهام علي) إبعاد شبح المرض، ومن ثم الشبهة الجنائية التي حاصرته بها القرائن والأدلة من كل جانب.
ومنذ اللحظات الأولى، يبدأ الفلم ببث التشويق والأجواء الغامضة ليجعلهما يسيطران على المشاهد، ويزدادان مع مرور الأحداث، حيث تتولد الأسئلة: هل ماجد فاقد للذاكرة فعلاً؟ أم أن أحداً يريد أن يوهمه بذلك، ويُعد له العدة ويخطط بمكر ودهاء بمعاونة عدة أشخاص لتوريطه في جريمة قتل لم يقترفها؟ ثم ما الدافع للقتل؟
لا جدال في أن أفلام الجريمة تكون دائماً مغلَّفة بالغموض، ولها توليفة خاصة تعتمد على الحبكة المترابطة والمنسابة بإيحاء مكثَّف، لتوليد الأسئلة الحائرة لدى المشاهد، بهدف إثارة حب الاستطلاع والتنبؤ بما سيجري من أحداث لتبديد الغموض. وبالطبع، فإن ذلك يأتي وفق منطق القصة التي يكتنفها الغموض، ولا يكتمل حلّ خيوطها سوى في المشهد الأخير.
ولتحقيق التشويق، اتبع المخرج في سرده لأحداث الفلم على البدء من النهاية؛ أي إنه يطالعنا في المشهد الأول بمنظر جثة على الأرض غارقة في دمائها، فيما يقف ماجد مذهولاً من المنظر الذي أمامه. ثم يبدأ الفلم بالاسترجاع المتسلسل للأحداث؛ ليضع المشاهد في بؤرة الصراع الذي يفسِّر معنى وجود هذه الجثة. بما يؤكد بالقطع أن الميت تعرَّض للقتل، ولم يمت لسب آخر كالانتحار أو السقوط من مكان عالٍ. ولكن منظر الجثة يفاجئ صاحب المنزل ماجد الذي يبدأ بالتقصي عبر "الفلاش باك".
غير أن استرجاع الأحداث لا يسير في وتيرة منتظمة؛ إذ يتنقَّل بين مشاهد عديدة متداخلة؛ فتظهر شخصيات جديدة في كل مرَّة، وفي ذلك ما قد يكون مربكاً للمشاهد، غير أن المخرج صاغها بمنطق يقبله العقل، وهذا ما أضفى على الفلم طابع الجذب الذي أشرنا إليه في البداية.
وحرص صانع الفلم على تجويد محاكاة الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، عام 2004م، فتذهب الكاميرا إلى الأماكن الحقيقية التي برزت في تلك الفترة، وتصوِّر الأحداث ضمن البيوت، والشوارع، والسيارات، ومدرسة البنات، وقسم الشرطة وغيرها، كما كان كل شيء في تلك السنة. وهي سنة ليس بعيدة كثيراً عنا الآن، لكن استرجاع التفاصيل الخاصة بها والمحافظة عليها تتطلب تركيزاً مكثفاً حتى لا يظهر ما يخل بزمن الرواية.
تميَّزت تلك الفترة الزمنية بتأثيرات التطرف الديني الذي أحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الصحوة الدينية. وبسببه اختلت المفاهيم لدى الشباب المنحازين والمنضمين للتيارات الدينية المتطرفة.
ولكن الفلم لم يكن واضحاً في طرحه، وبدا الأمر وكأنه إقحام غير متجانس مع قصة الفلم. فالحوار الذي يجري في المسجد يبدو حواراً منفصلاً لا يمت لقصة الفلم بصلة، رغم أنه مهم، إذ نخرج منه بفهم لمدى تأثُّر الشباب بشيوخهم، (وفاة الشيخ راجح).
ورغم ما في المشهد من إجادة في الحوار والملابس والمكياج الذي بدا طبيعياً، نبقى نتساءل: من هما هذان الشخصان؟ الفلم لا يقدِّم تمهيداً منطقياً للتعريف بالشخصيتين.